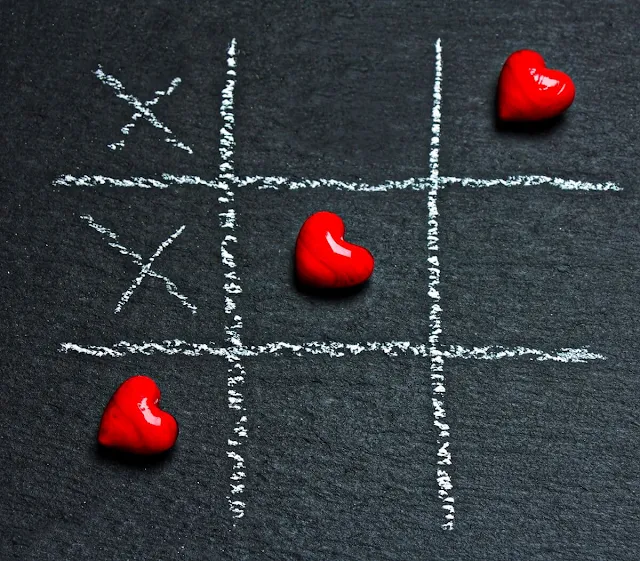مقتطف من رواية "صبوات" - هنري ميللر
ترجمة : خالد الجبيلي
وفيما كنت عائداً إلى البيت في مساء أحد الأيام، رأيت بطرف عيني واحدة من تلك المخلوقات الحسية من الغيتو، بدا أنها خرجت من بين صفحات العهد القديم. كانت واحدة من اليهوديات التي ينبغي أن يكون اسمها روث أو راحيل، أو ربما مريم.
مريم! ذلك هو الاسم الذي أبحث عنه. أخذت أسأل نفسي لماذا كنت أرى أن هذا الاسم رائع جداً؟ كيف يمكن لمثل هذه الاسم البسيط أن يهيج فيّ هذه العواطف الجياشة؟ مريم ... أجمل الأسماء. إذا كان بوسعي أن أقولب النساء جميعهن في الصورة المثالية، إذا كان بوسعي أن أمنح هذه المثالية كل الصفات التي أبحث عنها في المرأة، فإن اسمها سيكون مريم.
نسيت تماماً المخلوق الجميل الذي ألهمني هذه الأفكار. كنت أفكر بشيء ما، ومع تسارع خطواتي، ومع تسارع دقات قلبي بجنون أكثر، تذكرت فجأة وجه مريم، صوتها، شكلها، ملامحها التي عرفتها عندما كنت صبياً في الثانية عشرة. وكانت تدعى مريم بينتر. لم تكن تتجاوز الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من العمر، لكنها كانت ممتلئة، مفعمة بالحيوية، متألقة كزهرة يفوح شذاها- لا نظير لها. لم تكن يهودية، بل لم تكن توحي، لا من قريب أو بعيد، بذكرى تلك المخلوقات الأسطورية في العهد القديم ( أو لعلني لم أكن قد قرأت العهد القديم بعد). كانت تلك الصبية ذات الشعر الكستنائي الطويل، والعينين الشهلاوين النجلاوين، والفم الواسع قليلاً الذي يحيني بمودة وأنا ألقاها في الشارع، عفوية دائماً، مسترخية دائماً، موفورة الصحة دائماً ومتألقة بطبيعتها الطيبة، عطوفة، ومع ذلك حكيمة، متفهمة تماماً. ولم يكن من الضروري أن تبادرها بأسلوب أخرق: كانت تتقدم نحوي دائماً وهي تشع بهذه البهجة الداخلية السرية، تتدفق على الدوام. غمرتني، أسرتني، احتوتني كأمّ، أدفأتني كعشيقة، أتت إليّ كعروس جنية. لم أفكر بها أفكارا بذيئة: لم أشتهها أبداً، لم أرغب في مداعبتها. أحببتها من الصميم، حباً جماً، وكنت في كل مرة ألاقيها فيها، كنت أشعر وكأنني ولدت من جديد. كل ما كنت أطلبه هو أن تبقى حية، أن تكون من هذه الأرض، أن تكون في مكان ما، في أي مكان، في هذا العالم، وألاّ تموت أبداً. لم أكن آمل في أن أحصل منها على شيء، لم أكن أريد منها شيئاً. كان مجرد وجودها يكفيني. نعم، كنت ألوذ بالبيت، أتوارى، وأشكر الله بصوت عال لأنه بعث مريم إلى أرضنا هذه. يالها من معجزة! ويالها من نعمة أن يحب المرء هكذا!
لا أعرف إلى متى استمر ذلك. ولم تكن لدي أدنى فكرة إن كانت تعرف مدى هيامي بها أم لا؟ كنت عاشقاً، كنت غارقاً في الحب حتى أذنيَّ، كنت مع الحب. أن تحب! أن تستسلم تماماً، أن تسجد أمام الصورة القدسية، أن تموت ألف ميتة في الخيال، أن تقضي على كل أثر من الذات، أن تجد الكون كله متجسداً ومكتناً في الصورة الحية للآخر! نقول مراهقة. تباً! إنها جرثومة حياة المستقبل، البذرة التي نخفيها، التي ندفنها في أعماقنا، التي نخنقها ونكتمها ونبذل ما بوسعنا لندمرها ونحن ننتقل من تجربة إلى أخرى ونتعثر ونتخبط ونتيه عن الطريق.
وعندما كنت ألتقي بالمرأة المثالية الثانية - أونا غيفورد – كنت أمرض. في الخامسة عشرة من العمر والقرحة تنهش أعضائي الحية. كيف يمكنني أن أفسر ذلك؟ لقد خرجت مريم من حياتي، ليس بشكل مثير، وإنما بهدوء وصمت. لقد اختفت بكل بساطة، ولم أعد أراها، حتى أنني لم أعرف ماذا كان يعني ذلك. لم أفكر في الأمر. يأتي الناس ويذهبون، تظهر الأشياء وتختفي. وشأن الآخرين كنت في حالة مدّ وجزر، وكان كل شيء طبيعياً رغم تعذر تفسيره. كنت قد بدأت أقرأ، أقرأ بنهم. كنت أدور في داخلي، أطبق على نفسي، كما تطبق الزهور على نفسها في الليل.