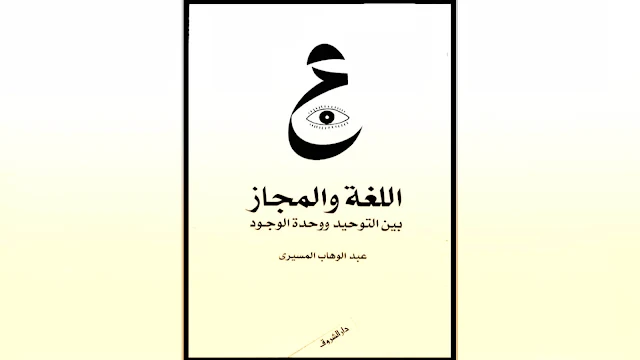ملخّص كتاب : اللغة والمجاز
بين التوحيد ووحدة الوجود
عبد الوهاب المسيري
الباب الأول
يتناول
الباب الأول من هذا الكتاب (اللغة والمجاز بين التوحيد ووحدة
الوجود، عبد الوهاب
المسيري، دار الشروق – القاهرة، الطبعة الأولى 2002.) الصور
المجازيّة باعتبارها تعبيراً معيّناً عن رُؤية الإنسان للكون (ومن ثم تسميتها
"الصور المجازية الإدراكية")، ويحاولُ في هذا الباب تحليل الصور
المجازية في عدة مجالات حتى يصل إلى رؤية الكون الكامنة وراءها.
الفصل الأوّل
فيتطرّق في الفصل
الأوّل لتعريف الصورة المجازية، ومنهج التحليل من خلال الصور المجازية. ويذهب
إلى أنّ المجاز اللغوي – أي الاستعارة والكناية والمجاز المرسل – قد يكون مجرّد
زخارف ومحسّنات في بعض الأحيان، ولكنّه في أكثر الأحيان جزء أساسي من التفكير
الإنساني، أي جزء من نسيج اللغة، التي هي جزء لا يتجزأ من عملية الإدراك. فنحن
نتحدّث عن "عين الماء" و"يد الكوب" و"رِجل
المائدة"، وهذه كلها صور مجازية نستخدمها دون أن نشعر، نظراً لشيوعها
وبساطتها. ولا يمكن إدراك بعض الظواهر الإنسانيّة المركّبة ولا الإفصاحُ عنها دون
اللجوء إلى المجاز المركّب. أي أنّ استخدام المجاز أمرٌ حتمي في معظم عمليات
الإدراك والإفصاح، خصوصاً تلك التي تتناول الظواهر التي تتّسم بقدرٍ عالٍ من
التركيب.(ص 13). وبذلك يوسّع المجاز من نطاق اللغة الإنسانيّة، ويجعلها
أكثر مقدرةً على التعبير عن الإنساني المركّب واللامحدود. أي أنّ المجاز اللغوي
هو أداة الإنسان للتعبير عن أفكار ورؤى مركّبة لايمكن التعبير عنها إلاّ بهذه
الطريقة.(ص 17). إلاّ أنّ تحليل الصور المجازيّة
كمدخل لفهم النصّوص، أدبية كانت أم سياسيّة، وإدراك مستوياتها الواعية وغير
الواعية، منهجٌ لم يستخدم بما فيه الكفاية في عالمنا العربي، مع أن مقدرته التحليليّة
والتفسيرية عالية إلى أقصى حدّ.
الفصلُ الثاني
أمَّا
الفصلُ الثاني، فيرصد ما تتصوره الصورتان المجازيتان الأساسيتان في الحضارة
الغربية الحديثة: الصورة الآلية والصورة العضويّة، وقد سُميتا كذلك لأن كلّ واحدة تحوي صورة مجازيّة مختلفة. الصورة المجازية
الأولى تصوّر العالم على هيئة كائن حيّ وحركته عضويّة، فهو ينمو بشكل عضوي. أمّا
الثانيّة فتصوّر العالم على هيئة آلة، فهوّ يتحرّك بشكلٍ آلي رتيب.(ص 29). ويبيّن كيف أنهما يعبّران عن رُؤيتين للكون قد تبدوان
مختلفتين، بل متعارضتين، ولكنهما في واقع الأمر متشابهتان إلى حدّ كبير، إلاّ من
بعض التفاصيل الهامشيّة. حيثُ يدوران في إطار كموني مادي يجعل مركز النماذج
كامناً فيه، فكلاهما صورتان مجازيتان تُعبّران عن نظام مادي مغلق، يتحرّك حسب
قوانين معروفة بشكل مسبق وحتمي. وهذه القوانين قد تكون كامنة في الكيان العضوي
ذاته، وقد تكون خارج الكيان الآلي، ولكنها على أية حال قوانين طبيعية ثابتة لا
تتغير – فالنبات سينمو بنفس الطريقة دائماً، تماماً مثل الآلة التي تتحرّك بنفس
الطريقة. وكلّ من الكيان العضوي أو الكيان الآلي يحوي داخله ما هو مطلوب لفهمه.
وكذلك فإن مكان الإنسان في الطبيعة الآلية لا يختلف كثيرا عن مكانه في الطبيعة العُضوية،
فحينما يعود الإنسان إلى الطبيعة العضوية فإنّه يذوب فيها، تماماً مثل خضوعه
لقوانين الطبيعة الآلية(ص 37). ولعلّ الفارق بين النموذجين هو
أن الطبيعة العضوية لا يمكن فهمها تماماً، فهي مليئة بالأسرار، على عكس الطبيعة
الآلية التي يمكن فهمها. ولذا، فإنّ ما يُطلَبُ من المرء في الإطار الآلي هو أن
يتبع الطبيعة بعقلانيّة شديدة، ويذوب فيها ببرود شديد. أمّا في إطار الطبيعة
العضوية، فإنّهُ يُطلَب منه أن يتبعها بكل عواطفه ويذوب فيها أيضاً، لكن وهوّ في
حالة نشوة وحرارة بالغة.
الفصل الثالث
في
حين أنّ الفصل الثالث فيتناولُ الجسد كصورةٍ مجازيّة أساسية تفرّعت عن الصورة
العضويّة. إذ تلاحظ مركزيّة الجسد في فلسفة كثير من الفلاسفة المحدثين، خصوصاً في
أواخر القرن التاسع عشر، حينما يسود الحديث عن "طفرة الحياة" (برجسون)،
وعن "الغريزة" (روسو)، و"إرادة القوة" (شوبنهاور ونيتشه)،
و"البقاء" (إسبينوزا وداروين ونيتشه)، و"النزعة الديونيزية"
(نيتشه)، وأنّ "الإنسان يخلق ذاته أثناء خلقه لظروف حياته الاقتصادية"
(الماركسية). ويمكن القول بأن كل الفلسفات الحسيّة والسلوكية والماديّة، تنكرُ
التجاوز وتجعلُ من الجسد، بشكل واضح أو كامن، أساس كلّ شيء، فهو مصدر المعرفة
(العقل كمخ، أو كصفحة بيضاء سلبية تتراكم عليها المعطيات). والحواس الخمس هي
المصدر الوحيد للمعرفة، والإنسان يعرّف في إطار احتياجاته الماديّة الجسديّة
وجهازه العصبي وغدده. وبالتالي لا يمكن فصل العواطف عن العقل، أو الجسد عن الروح،
أو الحقيقة الموضوعية عن الرأي، أو الذات عن الموضوع، أو أي شيء عن شيء آخر (ص 61). كما تلاحظُ مركزيّة الجسد
والجنس في فكر سيغموند فرويد (الذي يفوق في أهميّته ماركس، خصوصاً بعد سقوط
المنظومة الاشتراكية). وفرويد (في كثير من الأحيان) يستخدم مفردات الحلولية
الكمونية لتفسير السلوك الإنساني في كليّته، وكأن الإنسان جسد محض ودوافع جسدية
وجنسيّة فقط، يعيش متمركزا حول ذاته الطبيعية في عالم الطبيعة/المادة. ومن هنا كان
تركيزه على الأحلام واللاّشعور، وعلى مراحل تطوّر جسد الإنسان وعلاقته بجسده، فهذه
جميعاً عناصر حتمية ماديّة تُسقط الإرادة والاختيار الحرّ.
الفصل الرابع
بينما
يحاولُ في الفصل الرابع أن يحلّل الجنس كصورة مجازيّة، أو ما يسمّيه المسيري نهاية
الماديّة. فمع ظهور المنظومة العلمانيّة الشاملة، ومع استبعاد الماوراء، وبداية
هيمنة الرؤية الحلولية والمرجعية الكونية - ظهر في عصر النهضة في الغرب فكر وثني
يهمّش الإله أو يلغيه تماماً، ويركّز على الآن وهنا. وقد ترجم هذا نفسه في عالم
الفنون إلى الاهتمام الشديد بالجسد الإنساني، أما في عالم الفكر فقد ظهرت فكرة
الإنسان الطبيعي، الذي يوجد في الطبيعة/المادة ويُردُّ إليها. في هذا الإطار ظهرت
الصور المجازيّة العضوية، ثم ظهر الجسد كصورة مجازية أساسيّة، ثمّ تطوّرت الصور مع
تطور المجتمع، ومع تصاعد معدلات الحلولية والعلمنة، ظهرت قبّالاه مسيحيّة تربطُ
بين الجنس كصورة مجازيّة ورؤية الكون، كما ظهرت حركات "دينيّة"
ترخيصيّة. وبعد أن كان الإنسانُ يُردُّ إلى الطبيعة/المادّة، ثم إلى الجسد،
أصبح يُردُّ إلى القاسم المشترك بين الإنسان وكل الكائنات الطبيعية الأخرى، وهو
الأعضاء التناسليّة (ص 72).
الفصلان الخامس والسادس
في
حين أنّ الفصلان الخامس والسادس فيقصدان إلى تطبيق منهج تحليل الصورة المجازيّة
كمدخلٍ لفهم النموذج الكامن والمهيمن على العقل الصهيوني، سواء في علاقته بذاته أم
في علاقته مع الآخر. ولعل أبرز نموذج مُسيطر ومتحكّم في علاقة الصهاينة بالآخر ما
ذهب إليه ناحوم جولدمان – أحد رؤساء المنظمة الصهيونية - في خطاب له ألقاه في مونتريال بكندا سنة 1947، بقوله إنّ الدولة الصهيونية سوف تؤسّس في فلسطين، لا
لاعتبارات دينيّة أو اقتصادية، بل لأنّ فلسطين هي ملتقى الطرق بين أوروبا وآسيا
وإفريقيا، ولأنها مركز القوة السياسية العالمية الحقيقي والمركز العسكري
الاستراتيجي للسيطرة على العالم. (ص 93). ومعنى هذا أن الدولة الصهيونية
لن تنتج سلعاً بعينها ولن تقدّم فرصاً للاستثمار، أو سوقاً لتصريف السلع، ولن تكُون
مصدراً للمواد الخام والمحاصيل الزراعيّة، وإنّما سيتمّ تأسيسها لأنّها ستقدّم
شيئاً مُختلفاً ومغايراً وثميناً: دوراً استراتيجيّا يؤمّن سيطرة الغرب على
العالم، وهو دورٌ سيكون له دون شك مردود اقتصادي، ولكنّه غير مباشر.
الباب الثاني
أما
الباب الثاني من الكتاب فيتعامل مع موضوع أكثر تجريداً، وهو علاقة رؤية الكون
باللغة، وإشكالية علاقة الدالّ (المصطلح- الإشارة – الاسم) بالمدلول (المفهوم –
المشار إليه – المسمى).
الفصل الأوّل
فيحاول الفصل الأوّل من هذا الباب أن يعرّف هذه الإشكالية
وكيف أصبحت قضية فلسفية أساسية، رغم أنها قضية لغويّة مجردة، وكيف أن الرؤية
اللغوية التي تذهب إلى أن ثمة علاقة اتصال وانفصال بين الدال والمدلول، عادة ما
تستند إلى الرؤية التوحيدية التي تذهب إلى أن الإله مركز الكون، مفارق له لكنّه
يرعاه، فهو في علاقة اتصال بالعالم وانفصال عنه، وأن ثمة مسافة تفصل بين الخالق
والمخلوق. أمّا الرؤية التي ترى أن ثمة اندماجاً كاملاً بين الدال والمدلول أو
انفصالاً كاملاً بينهُما، فإنّها تستند إلى الرؤية الحلولية التي ترى أن الإله قد
حلّ تماماً في مخلوقاته، فألغيت المسافة بينهما وأصبح الخالقُ والكونُ جوهراً
واحداً.
الفصل الثاني
ويتناول
الفصل الثاني من الباب الثاني نوعين من الخطاب واللغة: اللغة المجازية متعددة
المستويات والأبعاد، في مقابل اللغة الأيقونية والحرفية، واحدية المستوى والبُعد.
ومرة أخرى يؤكّد هذا الفصل على أنّ اللغة المجازيّة تعبّر عن الرؤية التوحيدية
للإله باعتباره منفصلاً عن الكون متّصلاً به في آن، أما اللغة الأيقونية والحرفية
فهي نتاج اعتقاد تجسّد الإله في العالم وحلوله فيه وتوحده معه. فكلٌّ من
التأيقن والحرفيّة واحديّ، يفصلُ الدالّ عن المدلول، ويُلغي المسافة التي تفصلُ
بينهما، إمّا لحساب الدال أو لحساب المدلول. هذا على عكس المجاز، الذي يؤكّد كلاّ
من الاتصال والانفصال بين الدال والمدلول، كما يؤكّد المسافة التي تفصل بينهما،
وإمكانيّة التفاعل بينهما، وإذا كانت لغة المجاز تعبيراً عن محاولة الوصول إلى
قدرٍ معقول من اليقين، ومحاولة التقرّب من الإله، فإنّ اللغة الواحديّة تعبّر عن
محاولة بروميثية – فاوستيّة – شيطانيّة، للوصول إلى اليقين المطلق عن طريق افتراض
التطابق الكامل بين النصّ والواقع (في حالة اللغة الحرفية)، أو عن طريق الإشراق
(في حالة اللغة الأيقونيّة). (ص 165).
الفصل الثالث
والفصل الثالث تطبيق لبعض الأطروحات النظريّة
التي وردت في الفصلين الأول والثاني، إذ حاول تبيان أن ثمة فارقاً بين الأصولية
(التي تصدر عن الرؤية التوحيدية والإيمان بإله مفارق رحيم) والحرفيّة (التي ترى الإله متجسّدا في النص المقدّس وفي
المفسِّر صاحب القول الفصل، الذي يكتشف التطابق التام بين النصّ المقدّس والواقع
التاريخي العلمي). فالأصوليّة هي رفض لكثير من الممارسات الدينيّة وبعض تفسيرات
الكتاب المقدّس، التي تراكمت عبر العصور، ودعوةٌ للعودة إلى أصول الدين الأولى
وممارسات واجتهادات الأوّلين والصالحين والحكماء، ومحاولة تفسيرها تفسيراً جديداً،
وتوليد معان جديدة منها تتلاءم والزمان والمكان اللذين يوجد فيهما المفسِّر
"الأصولي". وهذه الأصول، لأنها "الكلّ" و"الجذر"
و"القيمة الحاكمة"، تشكّل الإطار العام لعمليّة اجتهاد مستمرة في كلّ
عصر، يقوم بها عقل المؤمن المفسّر المجتهد بالعودة إلى النصّ المقدّس. فالمفسّر
الأصولي، رغم رفضه لبعض التفاسير الموروثة، لا يلجأ إلى التفسير الحرفي، إلاّ إن
تطلّب النص المقدّس ذلك، وهو لا يجتزئ من النصّ المقدّس مقطعا ينتزعه من سياقه ثم
يفرض عليه أيّ معنى حرفي قد يروق له (ويتّفق ومصلحته) بل يُفسّر في إطار ما
يتصوّره المنظومة الدينية الكليّة، وفي إطار النصّ المقدّس في شموله وكليّته
وتركيبيّته، كل هذا يعني أن الاجتهادات التي يصل إليها الإنسان ليست هي ذاتُها
النصّ المقدّس، وإنّما تتراوح في قربها وبُعدها عنه، ومن هنا تظهر ضرورة الاجتهاد.
أمّا الحرفيّة في التفسير فهيّ أن يلجأ المؤمن بكتاب مقدّس ما إلى التمسّك بحرفية
النصّ، دون اجتهاد أو إعمال عقل، وكأنّ النص يحمل رسالة واضحة مباشرة صريحة مثل
القاعدة العلميّة، أو اللغة الجبرية، أو الصيغة السحريّة، أو الأيقونة التي تفضي
بمعناها لمن يتعبّد أمامها، بل كأنّ النصّ
هو تجسّد للإله في العالم، وكأنّ العالم هوّ كلٌّ عضوي مصمت، لا ثنائيات فيه ولا أسرار. (ص 177).
كما يحاول الفصل الثالث تجلّي هذه الإشكالية من
خلال دراسة بعض الحركات الحرفية في المسيحية واليهوديّة. ويتطرّقُ الفصل الرابع من
هذا الباب إلى إشكالية علاقة الدال بالمدلول، وعلاقتها بإشكالية التحيّز. ولعلّ
أبرز أشكال التحيّز هوّ ذاك الناجم عن ارتباط الدال بسيّاقه الحضاري الذي نشأ فيه
ومحدودية حقله الدلالي، وبالتالي قصوره عن الإخبار عن مدلوله إن نُقل إلى سياق
حضاري جديد، بل يصبح الدال في هذه الحالة مصدراً لدلالات لا توجد في الواقع،
وستاراً يخبّئ جوانب من المدلول. (197).
فريق تحرير مدوّنة منهجيّتي